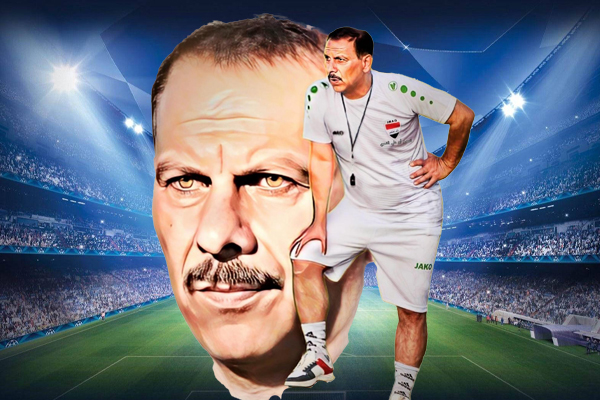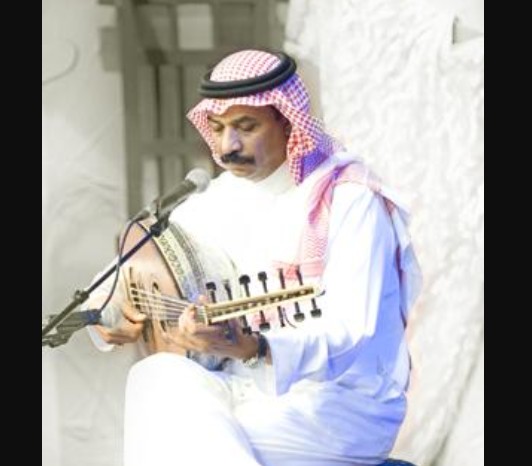تُعد شخصية الدكتور جميل الدويهي واحدة من أبرز الشخصيات الأدبية في العصر الحديث، حيث قدّم الكثير للثقافة العربية عبر شعره وأدبه. يعدُّ من أكثر الأدباء تأثيرًا في الساحة الأدبية اللبنانية والعربية، وهو شاهد على تطور الحركة الثقافية في الاغتراب. ومن أستراليا تحديداً أطلق لأوّل مرّة شعار “تعدّد الأنواع”، ومن خلال موقعه “كتب جميل الدويهي” ومؤلفاته التي بلغت سبعين مؤلفاً حتى الآن، في مشروع أدبيّ غنيّ، هو مشروع “أفكار اغترابيّة” للأدب المهجريّ الراقي.
فكان لمجلة مورنينغ ستارز شرف الحوار مع الدكتور الدويهي:
1- كيف تصف بداية مشوارك الأدبي والشعري، وما الذي ألهمك للانطلاق في هذا المجال؟
لم يكن القصد مطلقاً أن أكون أديباً أو شاعراً من غير النثر، عندما بدأت أتلمّس خطواتي الأولى في عمر ثلاثة عشر عاماً تقريباً.
كنت في طفولتي كثير القراءة، أدخل إلى مكتبة المدرسة وأستعير كتباً بالجملة.
وعزز هذا قدرتي في اللغة أولاً، فكنت من المتفوقين دائماً في اللغة والكتابة الأدبية.
ومنذ صغري أيضاً كنت خطيباً في المدرسة ثم في الثانوية. وتأثرت ببرامج الزجل اللبناني على التلفزيون، وبكتابات محمود درويش ونزار قباني، وطبعاً بما درسناه في المدرسة من الشعر القديم.
في تلك الفترة كنا مأخوذين بالشعر، ولم ننتبه إلى الغنى في النثر، حتّى قرأنا جبران ونعيمة و”لبنان إن حكى” لسعيد عقل، وو… وكتّاب غربيّين كثيرين.
وهذا التطور اللاحق، الذي حدث منذ بداية الدراسة الجامعيّة، أمدّني بالغنى الثقافي الذي أعتقد أنه كاف لترجمة شغفي الأدبي.
وبعد ذلك، شدّتني الفلسفة التي يتجنّبها أغلب الناس ويعتبرونها جافّة، واطّلعت على الكثير منها، قديماً وحديثاً، وكانت كتبي الفكريّة منذ “في معبد الروح” وصولاً إلى “أحاديث في أروقة الحكمة”، نتاج تلك الثقافة الفلسفيّة، حيث كوّنت لنفسي منهجاً خاصّاً، وعارضت فلسفات، وجادلت فلاسفة ومفكّرين كباراً.
لكن ما أحب أن أذكره هنا، هو أن اهتمامي بالنثر جاء بعد محاولات شعرية كثيرة. أقول “محاولات” لأنني حتى العام 2000، لم أكن قد وجدت نفسي في الشعر، وربّما لم أجدها الآن.
لكن في النثر (القصّة القصيرة، ثمّ الرواية، ثمّ الفكر) وجدت نفسي وأكثر. وأؤمن دائماً أنّ النثر أهمّ، وأكثر قدرة على حمل المضامين الفكريّة، وفي الأنواع الشعريّة السبعة التي كتبتها لم أتمكن من بث أفكاري كما فعلت في النثر.
2- كيف تصف تعاطيك مع القضايا الوطنية في أعمالك الأدبيّة؟ وإلى أيّ درجة تركّز على هذا الجانب في كتاباتك؟
في الشعر كتبت مجموعة لا بأس بها من القصائد عن الوطن، وما حدث فيه من مصائب وحروب لا نزال نعيش تداعياها إلى الآن.
بيد أنّ تركيزي على القضايا الوطنيّة لا ينطلق من أيديولوجيّة سياسيّة محدّدة، بل أكتب ما أراه بعين الضمير. والجميع يعرف أنّني بعد 17 تشرين الأول 2019، وقفت مع الثورة في لبنان، كما وقفت ولا أزال مع الربيع العربيّ.
وكنت دعوت إلى الثورات قبل ذلك بكثير. والأديبة مريم رعيدي الدويهي نشرت كتاباً على موقعي عن هذه القضيّة، وأثبتت أنّني صرخت بالثورة قبل أن يصرخ بها أصحابها في لبنان.
ولا أزال في كتاباتي – الصحفيّة خصوصاً – أعتبر أنّ الثورة حققت انتصارات، وأنّ الذين قمَعوها بقوّة الهراوات والبارود، لم يتمكّنوا من إزالة النهج الذي قامت عليه. وفي أعمالي القصصيّة أيضاً تحدّثت عن الحرّيّات، والمجاعات، والأزمات، خصوصاً في روايتي “حدث في أيّام الجوع” التي تؤرّخ لمرحلة مظلمة في لبنان، واعتبرَها البعض تصويباً سياسيّاً على فئة معيّنة، أو رمز، لكنّ الذي يقرأها يدرك أنّ ما قلته فيها ليس إلاّ الحقيقة بعينها، واستبدال كلمة “حدث” بـ “لم يحدث” هو كذبة كبيرة لا يهضمها حتّى أصحابها. أمّا في أعمالي الفكريّة، فقلّما أشير إلى الوطن الصغير، لأنّني أبحث عن وطن الإنسان الشامل الذي يتّسع لجميع الأجناس والأعراق، تحت قوس العدالة والخير والسلام.
وأذكر أنّني كتبت نصّاً بعنوان “أوطانكم” في معنى أنّ وطن الإنسان هو حرّيّته، وعندما يحلّق بجناحين إلى الفضاء البعيد، فذلك هو وطنه الأسمى، وعندما تصطدم جناحاه بالحديد، فذلك سجن وإن يكن في داخل الوطن.

3- بما أنّك نشرت حوالي 70 كتابًا، هل هناك مؤلَّف بعينه تعتبره الأقرب إلى قلبك، ولماذا؟
من الطبيعيّ أن يكون لأيّ والد عطف على جميع أولاده، ولكن بما أنّ أعمالي متنوّعة، فيمكنني أن أختار محطّات أعتبرها مهمّة في مجمل مسيرتي الأدبيّة.
ففي الرواية – نوفيلا مثلاً، أعتقد أنّ “طائر الهامة” أخذت حيّزاً كبيراً من الاهتمام، وشكّلت نقلة نوعيّة في رصيدي الكتابيّ. وفي الفكر كان “في معبد الروح” رأس الطاولة، تلاه “تأمّلات من صفاء الروح” شقيقه التوأم… وكلاهما عزيز عليّ.
وفي القصّة القصيرة “صمت الغابة” الذي يحتوي على أقصوصة تحمل العنوان نفسه، موجعة، دراميّة، من الصعب أن أحتمل قراءتها.
وفي الشعر “أعمدة الشعر السبعة” الذي يثبت ريادتي في سبعة أنواع شعريّة أكتبها معاً. وفي الشعر المدوّر العامّي “عندي حنين البحر للشطّ البعيد”. وفي الشعر المنثور “حاولت أن أتبع النهر… النهر لا يذهب إلى مكان”.
هذا الأخير استطعت أن أحمّله مضامين فكريّة أكثر من أيّ ديوان آخر، لأنّه “شعر أو نثر”، أي يمكن أن أتصرّف في مضمونه بحرّيّة أكثر… هذه الكتب الأقرب إلى قلبي، وهناك نخبة كبيرة من الكتُب على موقعي، ربّما تكون أفضل من تلك التي ذكرت، وأكثر غنى وثراء.
وهذا يتوقّف على ميول المتلقّي وذوقه الخاصّ.
4- كتبت عنك رسالة ماجستير، في ما يمكن وصفه بأنّه “إنجاز” مهمّ للأدب المهجريّ في أستراليا… كيف تنظر إلى هذا الإنجاز، وماذا بعده؟
كتبت عنّي طالبة لبنانية هي الأستاذة نداء عثمان رسالة ماجستير، وقدمتها إلى جامعة الجنان في طرابلس، وحازت على شهادة الماجستير بتفوق.
وقد ربطت بين المدرسة المهجرية الأولى في أميركا، ومدرستي في الأدب، وقارنت بينهما، وختمت بحثها الرفيع بمقارنة بين بعض السمات الأدبية في أدب جبران وأدبي. وهذا ليس “إنجازاً” فقط للأدب المهجريّ في أستراليا، بل هو “اختراق” يشرّف المغتربات كلّها، فللمرة الأولى بعد الرابطة القلمية تكتب دراسة جامعية، في بابها، عن أديب لبناني مغترب.
وكما علمت مؤخراً هناك أطروحة دكتوراه عن أعمالي في إحدى الجامعات العربية، قد تظهر إلى النور قريباً.
وهذا أيضاً مصدر فخري واعتزازي. وكم كنت أتمنّى مزيداً من الاهتمام بإرثي الأدبي المتنوع غير المسبوق.
وبينما أشدّ على يدي الأستاذة نداء عثمان ومَن يقتدي بها في الإضاءة على تراث “أفكار اغترابية”، فإنني أسجل استغرابي وحيرتي من ضآلة الاهتمام بما أقدمه مجاناً من تعب وسهر وتضحيات على جميع الأصعدة، ليس فقط في أستراليا، بل في مختلف الأصقاع.
لكن أتفهم الأسباب وراء ذلك، وأفهم لماذا يواجه رجل مثلي هذا الإهمال.
وفي الوقت نفسه لا أعرف لا السأم ولا الانكفاء.
5- كيف تنظر إلى دور الأدب في مجتمعاتنا العربية اليوم؟ هل ترى أن هناك تطوّرًا أو تحدّيات جديدة تواجه الأدباء؟
الأدب رسالة، والسؤال الصعب الذي يواجهه أيّ مشتغل في أيّة صنعة، هو: ماذا قدّمتَ في رسالتك؟ الرسالة هي الدور المفترض لكنْ المفقود اليوم، فما نراه أطنان من الشعر المنثور.
كثير من الشعراء وقلّة من الشعر. والنثر قليل الحظّ لأنّه يأتي في المرتبة الثانية بعد الشعر في اعتقاد الغالبيّة.
وهذا خطأ، فجبران ناثر أكثر منه شاعر، ونعيمه والريحاني كذلك، وطه حسين ونجيب محفوظ وأحمد أمين وتوفيق الحكيم.
في رأيي أنّ علينا تصويب المسيرة من ناحيتين: الأولى غربلة هذا العدد الهائل من الشعراء (موريتانيا وحدها بلد المليون شاعر)، فليس كلّ من تخرج من المدرسة الثانوية وعنده شغف بالكتابة أو لديه قصّة حبّ يريد أن يعبر عنها يكون شاعراً. الناحية الثانية هي التركيز على النثر: الرواية، القصّة القصيرة، الفكر الإنسانيّ…،
وهذه الأنواع قليلة اليوم لأنّ الجميع منصرفون إلى الشعر المنثور، ويا له من شعر غير مفهوم، لا يؤدّي وظيفة إنسانيّة، أو يقيم نظاماً للحياة والمجتمعات! للأسف هناك فشل ذريع على المستوى الأدبي بعد رحيل الكبار.
وأقرأ أحياناً عن أمسيات شعريّة ليس فيها شاعر واحد بالمعنى الحقيقي للكلمة.
علينا أن نضع خطوطاً عريضة لحالة أدبيّة نورانيّة ذات هدف أسمى، والتمهّل في الحكم على المنجز الأدبيّ.
أمّا إذا كان التطوّر يعني أن نستخدم الفايسبوك مثلاً في النشر، فهذا لا يعني أنّ وسائل التواصل هي الميزان الذي يحدّد مستوى الإبداع.
وكثرة الأصدقاء على فايسبوك لا تترجم حقيقة المضمون الأدبيّ، علماً أن أغلب مستخدمي التواصل ليسوا نقّاداً ولا يفهمون ما هو الأدب أصلاً.
ومن الفايسبوك نفسه تشجّع أناس لكي يتّخذوا صفة “شاعر” و”شاعرة”، وهم لا علاقة لهم بأيّ شعر لا من قريب ولا من بعيد.
التحدّي الكبير الذي يواجهنا اليوم هو هذه “الفوضى” غير الخلاّقة التي تساوي بين الذهب والحديد.
والويل لمن لا يعترف بهذه المساواة! وقد أُلغيتْ وظيفة الناقد لأنّه يُهان إذا نطق بالحقيقة العلميّة الصادقة، ولذلك لدينا معتدون على الأدب اليوم يزيدون بعشرات الأضعاف عن عدد المبدعين الحقيقيّين في كلّ العصور الأدبيّة السابقة، وليس من حسيب ولا رقيب.
هناك تحدّيات أخرى، مثل الغيرة من المبدع، والاستنساب في الأحكام، بحيث يصير الأولون آخرين والآخرون أولون، حتّى أنّ البعض يضطر إلى شراء الكتّاب والمستكتبين ليكيلوا إليه المديح.
أضف إلى ذلك إقلاع السواد الأعظم عن متابعة الأدب لصالح الركاكة والابتذال.
وهذا أفرزته التكنولوجيا التي أبعدت الناس عن رائحة الورق والكلمة الطيّبة والفاعلة. ولو أردت أن أعدّد لكم التحدّيات كلها لاحتجت إلى كتاب.
6- أنت تملك قدرة مميّزة في المزج بين التراث والحداثة في كتاباتك، كيف يمكن أن يكون ذلك جسرًا يربط الأجيال الجديدة بالثقافة العربية الأصيلة؟
لست أفكّر في موضوع الحداثة أو الأصالة عندما أكتب، ولا أعدّ قالباً لكي أسند عملي إليه، فالفكرة تسبق أوّلاً، والهيكل يأتي ثانياً.
المهمّ عندي أن أوصل أفكاري بأيّ طريقة ممكنة، وأبتعد عن التهويمات التي لا قيمة لها سوى تضليل المتلقّي.
وأنا مؤمن بالأدب الواضح الذي يقدّم خبزاً للناس، وليس الترف الذي يقول ولا يقول.
وبسبب تعدّد الأنواع التي أكتبها شعراً ونثراً، يمكنك أن تعثر على الأصيل والمحدث، وأحياناً يجتمعان معاً في نصّ واحد، ففي عدّة قصائد لي مزجت بين التدوير والميجنا، وهذه الأخيرة نوع من الشعر العامّيّ اللبنانيّ، كما مزجت بين الشعر التقليدي والتفعيلة، وأضفت إلى قصيدتي المدوّرة “وقلت: أحبّك” مقطعاً موزوناً على 13 تفعيلة ونصف التفعيلة. وهذا غير مألوف في الشعر العربيّ.
وفي الشعر المنثور الذي يخالف الوزن، لا أعتمد الهذيان أو الكتابة الآلية، فكل كلمة منتقاة ومختارة بعناية لتؤدي المعنى المقصود.
وأبتعد قدر الإمكان في كتاباتي النثرية عن المساحات الفارغة والوصف والحشد اللفظي الذي يملأ الورق، بل أركز فقط على المسار القصصي، لذلك جاءت رواياتي كلها من نوع “النوفيلا” أي القصّة الطويلة المختصرة. وهذه الأمثلة أسوقها ردّاً على سؤالكم المهمّ، ولولا ذلك، لما كان مهمّاً عندي في أيّ طريق أسير لكي أصل إلى قلب المتلقيّ وفكره.
وأعتقد أنّ الأجيال المقبلة التي ستقرأ الأدب، هي التي ستميّز بين الأديب الذي يكتب حبراً على ورق والأديب الذي يكتب من أجل مدينة القيم الخالدة، وشتّان بين ذاك وهذا في القيمة والتأثير.
7- يلاحظ أنّك في الآونة الأخيرة تركّز على النثر أكثر من الشعر، لماذا؟
كما ذكرت سابقاً، فإنّ النثر أكثر قدرة على حمل الأفكار التي تختلج في داخل الأديب. وأرى أنّ الانتشار اللبنانيّ يفتقر إلى النثر.
من هذا المنطلق انصبّ اهتمامي في الأعوام الثلاثة الماضية على المنجز النثري، فما كدت أنتهي من “صمت الغابة” (قصص قصيرة)، حتّى ذهبت إلى “رؤى من أجل مدينة بعيدة” (كتاب فكريّ)، و “المتقدّم في النور” (كتاب فكريّ)، وأتبعته برواية “هيلانة صور”، ثمّ “قدموس وهارمونيا”، وترجمت سيرة الإمبراطور الرومانيّ من أصل لبنانيّ “ألكسندر سافيروس”، وترجمت أيضاً قصصاً قصيرة لأدباء أستراليّين في بداية عهد الاستيطان.
وعدت إلى الفكر، فنشرت “أحاديث في أروقة الحكمة”… وأنا منصرف الآن إلى كتاب فكريّ ربّما يكون تتويجاً لأعمالي، بعنوان “الثلاثيّة المشرَّفة”.
ومقابل كلّ ذلك هناك مجموعة شعريّة واحدة باللغة المحكيّة اللبنانيّة أشتغل على إنهائها… وجميع ما ذكرته ظهر في فترة زمنيّة قصيرة جدّاً.
وهذا الاهتمام بالنثر أعتقد أنّه أساس المدرسة الاغترابيّة الجديدة. وإذا لم نستطع أن نجد رافعة لنقل أفكارنا العميقة ورؤانا الشاملة، فعبثاً نبني. والشعر وحده عاجز عن هذه المهمّة المقدّسة في نظري.
8- هذا الرصيد الكبير من النتاج الفكريّ – قد يكون تجاوز 16 كتاباً- ألا يحتوي على تكرار لقيم ومعتقدات محدّدة؟ أوليس هذا نوعاً من الإعادة المملّة؟
قد يكون هذا السؤال من أهمّ الأسئلة التي طُرحت عليّ مؤخّراً. ومن خلال الإجابة عليه أستطيع أن أناقش قضيّة مهمّة.
فعندما كتبت “في معبد الروح” باكورة أعمالي الفكريّة، اخترع البعض إشاعة أنّني تأثّرت بجبران خليل جبران، أو استوحيت من أفكاره،
أو حتّى نقلت عنه. لا أعتقد أنّ سارقاً ذكيّاً قد يذهب في عين الشمس ليسرق تمثالاً من الفضّة معروضاً في ساحة المدينة أمام الناس قاطبة.
قد أعمدُ إلى سرقة أديب غير معروف من أفريقيا، أو أميركا اللاتينية، أو الصين حيث اللغة لا يفهمها أحد، أمّا أن أسرق من جبران، فهذا يضعني تحت مقصلة الإدانة والإهانة، لماذا؟ لأنّ تلاميذ المدرسة الابتدائيّة يعرفون ماذا كتب جبران، وبهذا أصبح عرضة للسخرية.
ولا يرضى أحد بهذا مطلقاً إذا كانت فيه ذرّة من فكر… وجبران نفسه أخذ من الإنجيل المقدّس “يسوع ابن الإنسان”، واستوحى من نيتشه ومن ويليام بلايك، ونقل بالحرف أقصوصة قصيرة كتبها نفسها توفيق الحكيم في مسرحية “نهر الجنون”، كما كتبها باولو كويلو في روايته “فيرونيكا تقرّر أن تموت”…. وأيضاً أخذ جبران من آخرين، خصوصاً في موضوع التقمّص.
وإذا كانت بعض العناوين في “المعبد” تشبه عناوين في كتاب “النبيّ” مثلاً، فهذا لا يعني أنّ المضمون واحد، فلكلّ منّا رؤيته الخاصّة ومقاربته المختلفة. وجبران لم يضع حلولاً، بينما أنا وضعت حلولاً وأسساً لمدينة القيَم. واسمح لي أن أقول إنّ الذي روّج أنّ كتابي الفكريّ الأوّل يشبه كتابات جبران كان يعتقد أنّه الكتاب الفكريّ الوحيد الذي سأنتجه، ولكن بين عامي 2015- 2024 أنتجت حوالي 17 كتاباً فكريّاً متلاحقة، ضمّنتها قصصاً لا تخطر على بال أحد، مثل “الغراب”، “البحث عن باراباس”، “الخير فقط”، “طائر ليس له جناحان”… ووضعت نظريّات جديدة مثل نظريّة “القيمة” ونظريّة “البئر”، وناقشت فلاسفة ومفكّرين كباراً، وقد نشرت الأديبة مريم رعيدي الدويهي في كتاب، مقابلة مطوّلة معي عن مجادلة الفلاسفة، ومن بينهم جبران.
من ناحية أخرى يجب أن أشير إلى أنّ عالم الفكر هو عالم يسوده التشابه والنقاش، فقد تجد قصّة ذات عبرة من الصين تشابه قصّة من العراق، والفيلسوف يجادل فيلسوفاً كان قبله، ويقلّب تظريّاته، ويحاكيه. حتّى في الدين، فإنّ الديانات تتشابه وتأخذ الواحدة عن الأخرى، لانّ عجلة الزمان تدور حول نفسها وهي تجتاز المسافة بين الأمس واليوم، فالتأثّر لا يفسد للودّ قضيّة.
9- البعض يقول إنّ الأديب جميل الدويهي هو عميد المدرسة المهجريّة الثانية. كيف تحكم على مثل هذا الكلام؟
الحكم على مثل هذه المقولات يصدر عن العديد من الأساتذة الأكاديميّين والأدباء الذين يرون أوّلاً غزارة ما أنتجه من إصدارات في مختلف أنواع الأدب، وثانياً النوعيّة التي أحافظ عليها، ليكون الأدب المهجريّ من أستراليا فاعلاً ومؤثّراً في الحضارة وراقياً.
ليس الهدف عندي أن أكمل ما بدأه المهجريّون الأوائل في أميركا الشماليّة، بل أن أؤسّس مدرسة مختلفة تقوم على عناصر محدّدة، أهمّها تعدّد الأنواع غير المسبوق، واعتماد الفكر أساساً مهمّاً من أسس النهضة الاغترابيّة الثانية.
والفرق بيني وبين المهجريّين الأوائل ربّما لم يلاحظه أحد حتّى الآن، هو أنّني وضعت حلولاً للأزمات، ولم أكتف باللغة التهويميّة، فجاءت أعمالي أكثر مباشرة.
وعلى الرغم من اهتمام الدارسين بأدب الرابطة القلميّة، فإنّني أعتقد أنّ الأدب العربيّ في أستراليا، ومن خلال “أفكار اغترابيّة” سيكون له نصيب كبير في المستقبل من البحوث والدراسات، لأنّه يستحقّ فعلاً، وقد ضحّيت بالكثير من أجله، ودفعت أثماناً باهظة لأضعه على منارة.
لكنّه أدب فتيّ ناشئ، ويحتاج إلى وقت طويل لكي يقتنع به الدارسون. وأنتم تعرفون أنّ مجتمعنا العربيّ يضجّ بآلاف مؤلّفة من “الشعراء” و”الأدباء”، والزمن تغيّر. ولا أخفي أنّ بعض الناس يواجهون أدبي بسخريّة وتحقير. وهذا مألوف ولا يغيظني لأنّه يصدر عمّن لا يفعلون شيئاً، ونحن في انتظار غودو الذي لا يأتي من قبلهم.
العمادة للمدرسة المهجريّة الثانية لا أقبلها كلقب، وعندي مئات الألقاب التي لا أستخدمها.
ومعروف عنّي أنّني أؤمن بالمقارنة، ووضع النتاجات في الميزان للحكم عليها.
10- لزوجتك، الأديبة مريم رعيدي، دور بارز في تسليط الضوء على أعمالك الأدبيّة. كيف أثّرت هذه العلاقة الزوجية والأدبية على إبداعك؟
الأديبة مريم رعيدي الدويهي هي الوحيدة التي تعرف عنّي كلّ شاردة وواردة، وقيّض الله ثقافة لها، مكّنتها من متابعة أعمالي رصداً وتوثيقاً وتبويباً، وقد نشرت حتّى الآن العديد من الكتب التي تضيء على جوانب متعدّدة من أعمالي.
وهي تعوّض عن النقص الحادّ والفاقع في النقد لمنجزاتي المتنوّعة، خصوصاً في أستراليا.
لذلك أعتبرها حارسة “أفكار اغترابيّة”، بمعنى العين الساهرة، والحرص الملائكيّ على مدرستي التي أصبحت جامعة يقتدي الكثيرون بها.
ويزعجني كما يزعج مريم هذا التجاهل والتجهيل لثروة شعريّة، روائيّة، قصصيّة، تأريخيّة، فكريّة، ترجميّة، وباللغتين العربيّة والانكليزيّة، غير مسبوقة لدى أيّ أديب في تاريخ العرب.
ونطرح دائماً أسئلة حول هذه الحالة، فكأنّ الأدب العاديّ جدّاً هو القاعدة، والأدب الإبداعيّ حقّاً هو الاستثناء.
والمريمة تقول دائماً: من واجبي أن أواكب هذا الرصيد الهائل من الأعمال. كما تقول إنّ ما كُتب عن أعمالي كثير، لكنّ الدراسات الجامعيّة قليلة، فهناك جانب حذر لا نفهمه في مواجهة هذه المكتبة الضخمة من الإبداعات المتواصلة.
طبعاً إنّ ما تقدّمه مريم من جهد مشكور، يدفعني إلى مزيد من التضحيات والأمل بأنّ لكلّ غد صباحاً، ولكلّ قطرة حبر طريقاً إلى القلوب والضمائر. لذلك أتابع ولا يوقفني أحد عن سعيي وكفاحي إلاّ الله عزّ وجلّ.
11- هل تعتقد أن الأدب العربي يحتاج إلى المزيد من الانفتاح على الثقافات الأخرى؟ وكيف يمكن تعزيز هذا التبادل الثقافي؟
بالتأكيد، نحن بأمسّ الحاجة إلى المعرفة والاطّلاع على الثقافات الأخرى، لأنّ التلاقح المعرفيّ يغني الحضارة. ولا أعتقد أنّ العرب عاجزون عن مخاطبة الثقافات الأخرى، من الشرق إلى الغرب.
وقلّما تجد أديباً انطوائيّاً يسجّل النجاح، فالانطوائيّ يبقى في دائرة القرية أو الحيّ، أو الوطن الأصغر، ويظلّ إبداعه محدوداً. ومن خلال تجربتي، وجدت أنّ تعرّفي بالأدب الأستراليّ، والفلسفات والأفكار العالميّة المختلفة- ليس كلّها طبعاً- انعكس على كم كبير من الكتب التي نشرتها. ولولا هذه الثقافة لما وسّعت دائرة اهتمامي، وعبّرت بطلاقة عن مواضيع تتخطّى الواقع المألوف إلى قيم حضاريّة ونورانيّة.
وإنّ تعزيز التبادل الثقافيّ ينطلق أوّلاً من الرغبة في الثقافة، وربّما الحشريّة، والميل إلى التعلّم، وإغناء الذات برصيد خارج الجغرافيا الآنيّة. وأعتقد أنّ للمدارس والجامعات والمؤسّسات الثقافيّة والمجموعات الأدبيّة والإعلام دوراً مهمّاً يمكن القيام به على هذا المستوى. ولكنّ المبادرة الفرديّة تبقى الأساس، فالانفتاح مرتبط بالذات أوّلاً، وبشغف الإنسان في إثراء تجربته، وهو الذي يختار بين أن يكون أديباً محلّيّ النزعة، أو أديباً شموليّاً له رؤى إنسانيّة ووظيفة حضاريّة تمتدّ إلى ما وراء الخطوط التقليديّة المرسومة.
12- أخيرًا، ما هي رسالتك للشباب الذين يسعون لتحقيق طموحاتهم الأدبية والفكرية في الوقت الراهن؟
“لا تستعجلوا”. هذه الرسالة أكرّرها دائماً، ليس فقط للشباب الذين يسعون لتحقيق طموحاتهم الأدبيّة والفكريّة، بل أيضاً إلى طائفة المستعجلين إلى الشهرة. الأدب ليس نزهة في حديقة، ولا هو شغف، ولا رغبة في التشبّه في الآخرين. رأيت أناساً في العقد الثامن من أعمارهم لم يكتبوا في حياتهم شعراً، وفجأة أطلّوا علينا بـ “دواوين”. سألنا عن هذه الظاهرة، فقيل لنا إنّهم تقاعدوا ولم يجدوا شيئاً يفعلونه، فانصرفوا إلى الأدب، قائلين في أنفسهم: إذا كان فلان أديباً فما الذي ينقصنا؟
هذه مشكلة كبرى تضيف إلى العدد الهائل من “المبدعين” في عالمنا العربيّ، حتّى أصبحنا ننادي كلّ إنسان في الشارع بأديب وشاعر ودكتور، ووو… بينما الأدب الحقيقيّ هو معموديّة بالنار والسهر والنضال وخسارة عمر. هو خليط ثقافيّ يتداخل مع اللحم والعظم. الأدب ليس مواضيع إنشاء يكتبها تلاميذ الصفوف المتوسّطة، ولا خواطر عشق وغرام. ومن الصعب أن يفهم الناس العاديّون ما أقوله، فالكثرة تغلب الشجاعة. “لا تستعجلوا”، فهذا الأدب متين، أدخلوا إليه برفق. وهذه نصيحة من إنسان يحبّكم ويريدكم أن تنجحوا. فاهبطوا من تصوّراتكم وأحلامكم إلى نهر الواقع، وليغمر ماء المعموديّة أجسادكم وأرواحكم بحرارة الإبداع، وعندما تتشبّعون من الثقافات عودوا إلى الورق والحبر، لكي تصنعوا أدباً يليق بالحياة، وتليق الحياة به.